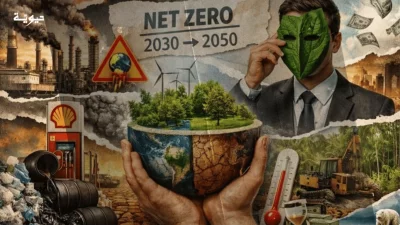الطبيعة هي الرحم الأول الذي يحتضن وجودنا؛ فإن ضعِفَت ضعِفنا معها، وإن فسدت، امتدّ الفساد إلى أجسادنا وأرواحنا. في سوريا، لم تكن الحرب مجرد نيران تلتهم المدن، بل كارثة بيئية غيّرت وجه الحياة، فسمّمت الهواء، ولوّثت المياه، وأثقلت الأرض بسموم ستظل آثارها لعقود.
لكن الأزمة البيئية لم تبدأ مع الحرب، فقد عانت سوريا من تدهور بيئي متراكم نتيجة سوء إدارة الموارد، وغياب السياسات المستدامة والتجاهل المزمن لقضايا البيئة. أدّى التلوّث الصناعي، والجفاف بين عامَي 2006 و2010، والاستغلال غير المنظَّم للمياه قبل عام 2011، إلى تفاقم معدّلات البطالة وتزايد انعدام الأمن الغذائي، ما دفع آلاف العائلات إلى النزوح نحو المدن. وقد ساهم هذا النزوح في زيادة الضغط على البنى التحتية، وأشعل فتيل الغضب الشعبي. لم تَكُن البيئة ضحية للحرب فحسب، بل شكّلت أيضًا أحد العوامل التي أسهمت في إشعالها.
واليوم، بعد أكثر من عقد من الدمار، تحولت الأزمات البيئية إلى قنبلة موقوتة تهدد مستقبل البلاد. غطّت الغارات السماء بسحب الدخان والسموم، وجعلت التنفس معركة يومية، بينما باتت المياه ناقلةً للأمراض بعد اختلاطها بالنفايات والصرف الصحي في ظل انهيار البنية التحتية. التقارير البيئية لا تترك مجالًا للشك: هواء سوريا من بين الأكثر تلوثًا في العالم، ومصادر المياه تئن تحت وطأة الملوثات، بينما يواجه السكان خطرًا لا يقل فتكًا عن نيران الحرب نفسها.
تلوث الهواء في سوريا: خطر صامت لكنه قاتل
لم تكن الحرب في سوريا مجرد دمار بشري وعمراني، بل أوجدت أزمة بيئية خانقة، حيث تحول الهواء نفسه إلى خطر غير مرئي يهدد الحياة. أدت العمليات العسكرية إلى إطلاق كميات هائلة من الغازات السامة، مثل أكاسيد النيتروجين والكبريت، التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي وأمراضًا مزمنة. زادت المشكلة في المناطق التي تعرضت لضربات متكررة، مثل حلب، الغوطة، وريف دمشق.
في شمال سوريا، تفاقمت المشكلة نتيجة انتشار تكرير النفط بطرق بدائية. خاصةً في دير الزور، الرقة، وأرياف الحسكة، حيث تُحرق كميات كبيرة من النفط الخام في مصافٍ غير منظمة، ما يؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من الغازات السامة والجسيمات الدقيقة في الهواء. كما ساهمت حرائق آبار النفط والمنشآت الصناعية، سواء بسبب الاستهداف العسكري أو سوء الإدارة، في تلوث الأجواء بـ الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مركبات مسرطنة تتراكم في الهواء والمياه والتربة.
لم يكن حرق النفايات في العراء أقل خطورة، حيث أصبح وسيلة اضطرارية للتخلص من القمامة في ظل انهيار البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى انبعاث الديوكسينات والفورانات، وهي مركبات سامة تؤثر على الجهاز العصبي والمناعي.
الجسيمات الدقيقة (PM2.5): القاتل الخفي
لكن أخطر ما في هذا التلوث هو الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات متناهية الصغر تنتج عن الانفجارات، حرائق الغابات، والمصانع المدمرة. نظرًا لصغر حجمها، تستطيع هذه الجسيمات التغلغل بعمق في الرئتين والانتقال إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى أمراض تنفسية مزمنة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان والسكتات الدماغية.
تشير دراسة استقصائية أولية للضرر البيئي في سوريا, أن 72% من سكان سوريا تعرضوا لمستويات خطيرة من هذه الجسيمات عام 2015، مقارنة بـ 69% في 2010، مع تسجيل أعلى المعدلات في حلب، دمشق، والغوطة الشرقية، حيث تراكمت الملوثات الناجمة عن القصف والانفجارات لسنوات.
تزايد الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء
تزامن هذا التلوث مع ارتفاع واضح في معدلات الأمراض، حيث ازدادت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بنسبة 17% بين 2010 و2017، بإجمالي 7,684 وفاة. كما ارتفعت معدلات الإصابة بالربو والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، لا سيما بين الأطفال وكبار السن. وفي الغوطة الشرقية، التي تعرضت لهجمات كيميائية متكررة، سجلت زيادة في حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية بسبب التعرض المستمر للهواء الملوث بمواد سامة.
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
أثرت الحرب السورية بشكل متباين على مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فمن جهة، أدى تدمير المنشآت الصناعية، وتعطل إنتاج النفط والغاز، وانخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع إجمالي الانبعاثات الكربونية مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. ومن جهة أخرى، تسببت ممارسات الحرب في زيادة التلوث الهوائي، حيث انتشرت المصافي النفطية البدائية في الشمال الشرقي وحرائق الغابات الناتجة عن القصف والاحتطاب الجائر، مما رفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأثّر على المناخ المحلي وزاد من الأمراض التنفسية والوفيات المرتبطة بتلوث الهواء.
تلوث المياه وتداعياته
أدت الحرب السورية إلى انهيار واسع للبنية التحتية للمياه، حيث خرجت 35% من محطات المياه عن الخدمة بحلول عام 2019، لا سيما في المناطق الشمالية والشرقية، مما أجبر ملايين السكان على الاعتماد على مصادر غير آمنة. في بعض المناطق مثل دير الزور والرقة، تسبب توقف محطات الضخ في اضطرار السكان لاستخدام مياه الآبار غير المعقمة، مما زاد من مخاطر انتشار الأمراض. كما أدى انتشار الآبار العشوائية إلى استنزاف المياه الجوفية وتلوثها بسبب تسربات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية، حيث ارتفعت نسبة التلوث الكيميائي والبكتيري في المياه الجوفية إلى مستويات غير آمنة.
تفشي الأمراض المنقولة بالمياه
نتيجة لهذه الأزمة، تفشت الأمراض المنقولة عبر مصادر المياه، حيث سُجلت أكثر من 55,000 إصابة بالكوليرا والتهاب الكبد A في شمال سوريا عام 2015. كما ارتفعت حالات الإسهال الحاد بنسبة 47% مقارنة بقبل الحرب، خاصة بين الأطفال، بسبب استهلاك المياه الملوثة، وأظهرت الدراسات أن أكثر من 60% من مصادر المياه في المناطق المتضررة تحتوي على نسب خطيرة من بكتيريا الإشريكية القولونية.
تلوث المياه بالمواد السامة
إضافة إلى ذلك، ساهم انهيار البنية التحتية في توقف محطات معالجة المياه، مما أدى إلى تصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الأنهار، ما تسبب في انتشار البكتيريا والطفيليات في مياه الشرب، وهو ما زاد من معدلات الأمراض المعوية بين السكان. كما أدى تكرير النفط العشوائي في شمال شرق سوريا إلى ارتفاع مستويات الهيدروكربونات السامة في المياه، مما رفع مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية والتسممات المزمنة. وأظهرت الاختبارات أن مستويات الرصاص في بعض مصادر المياه تجاوزت الحد المسموح به عالميًا بمقدار 4 إلى 6 أضعاف.
تأثير تلوث المياه على الزراعة
أدى تدمير أنظمة الري إلى اعتماد 70% من الأراضي الزراعية على مياه ملوثة أو غير كافية، مما أثر على الأمن الغذائي. في المقابل، أظهرت دراسة أن المناطق التي لا تزال تمتلك محطات معالجة مياه عاملة شهدت انخفاضًا في الأمراض المنقولة بالمياه بنسبة 35%.
تجربة رواندا في التعافي البيئي بعد الحرب: دروس مستفادة لسوريا
بعد الحرب الأهلية والإبادة الجماعية عام 1994، ورثت رواندا أزمة بيئية حادة، حيث فقدت 60% من غطائها النباتي بسبب النزوح الجماعي وتوسع المخيمات العشوائية في المناطق الطبيعية. وفي مواجهة هذا التحدي، أدرجت الحكومة البعد البيئي في خطة "رؤية 2020" التنموية، ما يميز التجربة الرواندية ليس فقط نجاحها البيئي، بل قدرتها على دمج البيئة في مشروع وطني شامل للتعافي، حيث لم تُعامل الطبيعة كـ"ضحية ثانوية" للنزاع، بل كفاعل مركزي في بناء السلام وإعادة الثقة.
على مستوى الطاقة، أنشأت الدولة آلاف وحدات البيوغاز المنزلية والمؤسساتية التي تحول روث الأبقار إلى غاز للطهي، مما قلل الاعتماد على الحطب وحسّن صحة العائلات. وفي قطاع المياه، لجأت إلى تطوير أنظمة الأراضي الرطبة الصناعية لمعالجة مياه الصرف بوسائل طبيعية، بديلاً عن المحطات المكلفة والمعقدة، ضمن خطة وطنية لحماية الموارد المائية. أما في مجال التربة، فتبنّت رواندا ممارسات الزراعة الحافظة، مثل بناء المدرجات الزراعية، وزراعة المحاصيل الغطائية، واستخدام الأسمدة العضوية، إلى جانب فرض قيود على الزراعة في المنحدرات شديدة الانحدار، مما ساهم في الحد من التآكل وزيادة إنتاجية الأرض.
الأهم من ذلك، أن رواندا لم تكتفِ بالمشاريع البيئية فحسب، بل أسست مؤسسات قوية مثل هيئة إدارة البيئة (REMA)، وفعلّت القوانين البيئية وربطت التنمية بالاستدامة، مدعومة من شركاء دوليين مما مكّنها من تحويل رؤيتها البيئية إلى واقع ملموس.
من التجربة الراوندية إلى التجربة السورية
قد لا ينفع "النسخ واللصق" من التجربة الرواندية لسوريا، لكن يمكن استلهام روحها: الاستثمار في البيئة كرافعة للعدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الإغاثة العاجلة والاستدامة طويلة الأمد. من هذه الزاوية، يصبح التعافي البيئي ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مشروعًا أخلاقيًا ومجتمعيًا يتطلب شراكة بين الدولة، المجتمع المدني، والدعم الدولي.
البيئة ليست ترفًا مؤجلًا لما بعد السلام، بل شرط من شروطه. فالتربة المسمومة، والهواء القاتل، والمياه الملوثة، لا تنتظر إعادة الإعمار السياسي أو الاقتصادي، بل تنخر ببطء في صحة السكان ومقوّمات الحياة. إن تعافي سوريا لن يكتمل من دون خطة إنقاذ بيئية متكاملة، تتجاوز المسكنات المؤقتة، و تؤسس لنهج استدامة حقيقي.